محاضرة
محاضرة الشيخ راشد الغنوشي عن "الدين و الدولة في الأصول الإسلامية و الأجتهاد المعاصر"

من اهم جلسات ندوة "الدين والدولة في الوطن العربي" التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالاشتراك مع المعهد السويدي في الاسكندرية، تلك الجلسات التي ناقشت حال مصر وتونس بعد الثورة في البلدين.
الجلسات التي ناقشت الأوضاع في البلدين شهدت طرح آراء شتى ومتباينة، وشهدت نقاشات ساخنة.
السبب في ذلك بالطبع ان البلدين شهدا صعود القوى الاسلامية الى السلطة .
يضاف الى هذا ان الندوة شهدت حضور الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ثاني أكبر الأحزاب التونسية من حيث التمثيلية النيابية في تونس اليوم، وألقى محاضرة ضمنها بعنوان "الدين و الدولة في الأصول الإسلامية و الأجتهاد المعاصر" .
تفريغ المحاضرة من أعداد الموقع الرسمي للشيخ
موضوع علاقة الدين بالدولة من اهم المواضيع التي تواجهنا في تونس ونحن في مرحلة بناء دستور ونظام جديدين، نطمح ان يكون نظاما ديمقراطيا يحترم حقوق الانسان.
الموضوع اشكالي ويطرح علينا بالضرورة تناول العلاقة بين الإسلام والعلمانية. هل هي علاقة تضارب وتخارج ام هي علاقة تداخل؟ متداعيات هذا السؤال هي العلاقة بين الإسلام والحكم، الإسلام والقانون، وكل هذه الإشكاليات. يبدو اننا عندما نتحدث عن العلمانية والإسلام، كأننا نتحدث عن الواضحات البينات. بينما قدر من الغموض غير قليل، وقدر من التعدد في الفهم غير قليل، أيضا، يواجهنا بحيث نحن لسنا إزاء علمانية واحدة بل إزاء علمانيات، وكذا الإسلام أيضا بحكم ماهو مطروح في الساحة، نحن ازاء اكثر من إسلام واحد، أي اكثر من فهم له.
تبدو العلمانية وكأنها فلسفة، وكأنها ثمرة تأملات فلسفية جاءت لمناقضة ومحاربة التصورات المثالية والدينية، غير ان الأمر ليس كذلك، اذ ظهرت العلمانية وتبلورت في الغرب كحلول إجرائية، وليست فلسفة او نظرية في الوجود بقدر ماهي ترتيبات إجرائية لحل إشكالات طرحت في الوسط الأوروبي. أهم هذه الإشكاليات ظهرت بفعل الانشقاق البروتستانتي في الغرب، الذي مزق الاجتماع الذي كان يدور في اطار الكنيسة ألكاثوليكية بما فرض الحروب الدينية في القرن السادس عشر والسابع عشر، هكذا بدأت العِلمانية (او العَلمانية).
النخبة التونسية أكثر تأثرا بعلمانية خصوصية وهي خصوصية فرنسية، حيث يقصى الدين في المجال العام و تعتبر الدولة نفسها حارسة الهوية. جاءت العلمانية باعتبارها ترتيبات إجرائية لاستعادة الاجماع الذي مزقته الصراعات الدينية. هنا يأتي السؤال: هل نحن في حاجة الى العلمانية باعتبارها ترتيبات إجرائية؟ ربما اهم فكرة في خلاصة هذه الإجراءات هي فكرة حيادية الدولة، أي ان الدولة يجب ان تكون محايدة إزاء الديانات ولا تتدخل في ضمائر الناس،الدولة مجالها "العام" بينما الدين مجاله "الخاص"، هذا ما انتهت اليه هذه الإجراءات رغم انها اختلفت في علاقتها بالدين. في الولايات المتحدة تدخل الدين في المجال العام تدخلا واضحا، فرغم ان هنالك تمايزا، الا انه يبقى هنالك تأثير كبير فخطب الزعماء مشحونة بالتصورات الدينية، وخلال الحملات الانتخابية الدين مطروح، وكذلك الصلاة في المدارس موضوع مطروح، وموضوع الإجهاض وعلاقته بالدين. ذلك في الحقيقة لأن أمريكا انشأها المهاجرون الانجيليون الهاربون بدينهم من الاضطهاد الكاثوليكي في أوروبا، ولذلك يُنظر اليها على انها "ارض الميعاد"، الأرض التي تتحقق فيها الأحلام التي وردت في التوراة والانجيل.
يقول المفكر الفرنسي توكفيل : " ان اقوى حزب في أمريكا هو الكنيسة بطبيعة النفوذ الكبير الذي تتمتع به في المجتمع الأمريكي". والحال ليس كذلك في أوروبا، فبينما الذين بإمكانهم ان يؤموا الصلاة في أمريكا يفوق عددهم 50 بالمائة، في أوروبا قد لا يتجاوز عددهم 5 بالمائة. في أوروبا هناك اختلاف في علاقة الدولة بالدين بين المنظور والإرث الفرنسي والإرث الانقلوسكسوني، حيث يصل الأمر في المملكة البريطانية ان تجمع الملكة بين السلطتين الزمنية والدينية. الفصل الكامل والكبير هو الذي يعرفه الإرث الفرنسي بسبب المصادمات التي حصلت، في تاريخ فرنسا، بين الدولة التي أنشاها الثائرون والإرث الكنسي الكاثوليكي. حتى في أوروبا، اذن، نحن لسنا إزاء تجربة واحدة في العلمانية، غير ان نخبتنا في تونس اكثر تأثرا بعلمانية خصوصية في الحقيقة، حتى في المنظور الغربي، وهي خصوصية فرنسية، حيث يُقصى الدين من المجال العام، وتعتبر الدولة نفسها حارسة الهوية. ولذلك فإن الديني بكل رموزه، في هذا المنظور، لا ينبغي ان يتدخل في المجال العام، وهذا الذي جعل فرنسا البلد الوحيد الذي لم يقبل غطاء الرأس بالنسبة الى المرأة المسلمة بينما لم نر هناك ازمة في أي بلد أوروبي اخر حول موضوع الحجاب، وما ذلك الا بسبب خصوصية العلاقة المتوترة بين الدولة والدين في خصوصية التجربة الفرنسية، في هذا الموضوع.
ربما اهم اجراء أبدعه النظر العلماني على هذا المستوى هو حيادية الدولة، أي ان الدولة هي الضامنة لكل الحريات الدينية والسياسية، لا ينبغي ان تتدخل لصالح هذا الطرف او ذاك. نحن نتساءل عما اذا كان الإسلام في حاجة الى مثل هذا الإجراء، أي حيادية الدولة إزاء الديانات.
منذ نشأ الإسلام جمع بين الدين والسياسة، بين الدين والدولة،فالرسول صلى الله عليه وسلم هو مؤسس الدين ومؤسس الدولة في نفس الوقت. وقد كانت البيعة الأولى للمجموعة التي قدمت من يثرب الى مكة بيعة دينية للرسول صلى الله عليه وسلم ان يؤمنوا بالله ورسوله، لكن البيعة الثانية في السنة الموالية كانت سياسية : ان يحموا النبي ومن معه اذا قدموا اليهم حتى بسيوفهم ان هوجمت المدينة. اسم "المدينة" هذا هو تعبير مهم جدا: كون هذا المكان كان يطلق عليه اسم "يثرب"، وأصبح يحمل اسم "المدينة" بما يدل بوضوح على ان الإسلام ليس دينا فقط وإنما يحمل معنى حضاريا، فهو نقلة بالناس من مستوى البادية الى المستوى المديني او الحضاري، ولذلك اُعتُبِر من الكبائر التبدي بعد تحضٌر، بمعنى انه اصبح يعتبر اثما على الذين تحضروا ان يعودوا الى البادية. ولذلك، لا عجب ان الإسلام مصَّر الأمصار، فحيثما حل أنشأ المدن، والمدينة التي أنشأها الرسول صلى الله عليه وسلم تدل عن ان الإسلام دين حضارة وليس دين بداوة. ولذلك، فإن اول مدينة أنشأها سميت بـ : "المدينة" التي تستحق هذا الاسم بجدارة، اذ نقلت تلك القبائل المتناحرة من مستوى بدوي الى مستوى حضري، أي مستوى الدولة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس في المسجد، كان اماما للدين، وفي نفس الوقت، كان اماما للسياسة يقضي بين الناس، وكان يقود الجيوش، ويعقد المعاهدات، ويقوم بكل الإجراءات.
من أهم وأول الإجراءات في هذا الصدد، التي تهمنا، هو أنه أول ما نزل في المدينة أنشأ المسجد، والإجراء الثاني هو انه سن دستورا اسمه "الصحيفة". هذه "الصحيفة"، التي هي ربما من أقدم الدساتير في العالم، تضمنت جملة مواثيق بين المهاجرين والأنصار بمختلف قبائلهم، الذين اعتبرهم امة، والقبائل اليهودية من سكان المدينة الذين اعتبرتهم كذلك أمة، أي يشكلون امة من دون الناس. وهنا الحديث ليس عن امة الدين، وإنما عن امة السياسة. وهنا نقف على اهم مصطلح طرحه الفكر الإسلامي الحديث، عن طريق محمد سليم العوّا ومحمد عمارة، وهو "التمايز بين الديني والسياسي" مقابل مفهوم الفصل بين الدين والسياسة في الاطار الغربي.
ففي هذه الصحيفة التمايز واضح بين الديني والسياسي، فالمسلمون أمة عقيدة، واليهود أمة عقيدة، وهما مع بقية سكان المدينة يشكلان جمعا يمثل امة من دون الناس، وهي أمة مفتوحة لمن لم يلتحق بأرضها، كما هي مفتوحة للأجيال القادمة ّوالذين جاؤوا من بعدهم" وهذا مفهوم الأمة السياسي: وظل هذا التمايز واضحا في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا اختلط الأمر أحيانا بين ماهو ديني، سلبه التقيد والإلزام وماهو سياسي وهو مجال للاجتهاد. أحيانا كان الأمر يختلط على الصحابة فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا وحي ملزم ام هو رأي ومشورة. عندئذ قد يختلفون معه في الرأي. ففي أكثر من مرة خالف الأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره رئيسا للدولة. والشيخ الطاهر بن عاشور فصّل تفصيلا جيدا بين ما سماه "مقامات النبي"، اذ للنبي مقامات، فإن كان في مقام النبوة فهذا مقام التلقي والطاعة، اما اذا كان في مقام قائد الجيش والسياسة فقد يختار للجيش موقعا، ويأتي صحابي بقول له: والله أرى ان الموقع الآخر أفضل. وبالفعل يتنازل النبي عن رأيه، ويأخذ برأي هذا الصحابي.
أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنشأ المسجد. ثم سن دستورا اسمه "الصحيفة" التي هي ربما من أقدم الدساتير في العالم. و فيها التمايز واضح بين الديني و السياسي. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم في المدينة وهم يُأبَّرون النخل، فقال (بحكم انه قادم من مكة وليس في خبرته معرفة بالزراعة) ما أرى هذا مفيدا أن تضعوا هذا الشيء. فظن اهل المدينة او قسم منهم انه وحي، فلم يأَبّروا النخل تلك السنة فأتى شيصا أي مرا. فسألوه : لماذا أمرتنا بهذا ؟ فقال " أنتم أعلم بأمور دنياكم. فليس من مهمة الدين تعليمنا أساليب الزراعة، وأساليب الصناعة، وحتى أساليب الحكم، وكيف ندير الدولة، لأن كل هذه تقنيات، والعقل مؤهل فيها الى ان يصل الى الحقيقة من خلال تراكم التجارب. مهمة الدين ان يجيبنا عن القضايا الكبرى التي تتعلق بوجودنا، وأصلنا، ومصيرنا، والغاية التي خلقنا لأجلها، وأن يعطينا نظام قيم ومبادئ يمكن ان تمثل توجيهات لتفكيرنا، وسلوكنا، ولأنظمة الدولة التي نسعى اليها، أي مرجعية قيمية.
منذ نشأة الإسلام وعبر امتداده التاريخي، لم يعرف هذا الفصل بين الدين والدولة، بمعنى اقصاء الدين عن الحياة. وظل المسلمون منذ العهد النبوي، وحتى يومنا هذا، متأثرين قليلا او كثيرا بنظرتهم الى انفسهم على انهم مسلمون، وينبغي ان يستلهموا من الإسلام وتعاليمه موجهات لحياتهم المدنية مع بقاء التمييز واضحا. هذا التمييز بين ماهو ديني وماهو سياسي واضح حتى عند الفقهاء، فالفقهاء ميزوا بين نظام المعاملات، نظام العبادات، حيث اعتبروا الأخير مجال التقيد (الصلاة، الصوم، لماذا نصلي 5 صلوات؟ لماذا بعضها فيه 3 ركعات والبعض الاخر 4؟). هذا مجال الثوابت والتقيد والعقل غير مؤهل في هذا المجال، ففي مجالات العقائد والعبادات، وعدد محدود من المسائل، العقل غير مؤهل لأن يدرك الحقيقة. ولكن مجال المعاملات هو مجال البحث عن المصلحة، لأن الإسلام جاء لتحقيق مصالح العباد. كما أقر الفقهاء الكبار، من الشاطبي الى ابن عاشور، ان المقصد الأسني لنزول الرسالات هو تحقيق العدل ومصالح الناس. هذه المصالح تتحقق من خلال اعمال العقل في ضوء موجهات، ومقاصد، ومبادئ وقيم الدين. لذلك ظل هنالك مجال للمعاملات يعرف تطورا مستمرا، ومنه نظام الدول، وهذه تمثل المتغيرات، بينما ماهو عقائدي وشعائري وماهو قيمي أخلاقي يمثل الثوابت.
كانت الدولة عبر التاريخ الإسلامي متأثرة بالإسلام، على نحو او اخر، في ممارساتها، والقانون يسنه البشر في ضوء القيم الإسلامية كما يفهمونها. ومع ذلك ظلت الدول إسلامية، لا بمعنى ان قوانينها ومسالكها وتراتيبها وحْيِيَّة، وإنما هي اجتهاد بشري قد يوافقه اجتهاد ويخالفه اخر، تمارس قدرا من الحياد. عندما أرادت الدولة العباسية، مثلا، ان تتدخل في فرض فهم للإسلام على الأمة، يذكر ان الامام مالك طلب اليه المنصور وقال له" لقد كثرت الاختلافات والاجتهادات المنبثقة من الدين الواحد حتى خشي على تشتت الأمة، وطلب منه المنصور جمع كل هذه الأقوال في منظور واحد، وفعلا كتب كتاب الموطأ جمعا بين مختلف الأقوال. فأعجب به المنصور، أيما إعجاب، حتى أراد ان يكون القانون الملزم لكل الأمة الإسلامية، لكن الامام مالك فزع وهاله الأمر وقال : لا تفعل يا أمير المؤمنين! فقد تفرق أصحاب رسول الله في الأمصار ومعهم علم كثير، وهذا ما بلغني أنا، فدع الناس وما يختارون. فظل لشمال افريقيا مذهب، ولأهل مصر مذهب، ولأهل الشام مذهب اخر. لأنه في غياب كنيسة في الإسلام، لا يبقى سوى حرية الاجتهاد، وستتعدد بطبيعة الحال هذه الاجتهادات المنبثقة عن نفس المنبع، ولا ضير في ذلك بما يؤسس لحرية الفكر والاجتهاد ولتعددية سياسية ومذهبية.
غير أننا اذا احتجنا الى سن قانون في ظل هذا التعدد، لا بد لنا من آلية. ولعل" أفضل الية توصل اليها البشر اليوم هي الآلية الديمقراطية، والآلية الانتخابية، التي تفرز ممثلين للأمة بما يجعل الاجتهاد اليوم ليس اجتهادا فرديا وإنما جماعيا يقوم به ممثلو الأمة المنتخبون، وذلك في غياب كنيسة تمثل المقدس فوق الأرض، وحيث ليس هناك من ناطق باسم القرآن والإرادة الإلهية. الإرادة الإلهية تجليها الوحيد في الأمة، التي تعبر عن الإرادة الإلهية من خلال تدافعها، وليس من خلال احتكار امام او حزب او دولة. ولذلك كانت للامام احمد ثورة معروفة : أنه، في عهد الإمام المأمون، وهو مثقف كبير، فكر في جمع الأمة على رأي واحد بعد أن لاحظ تشتتها، وكان قد تأثر بمدرسة المعتزلة التي رغم أنها اشتهرت على انها مدرسة عقلية، ولكن كثيرا ما أصحاب العقول تغرهم عقولهم ويريدون ان يفرضوا منتوجات عقولهم على الناس. وفعلا قرر المأمون ان يفرض تفسيرا معينا للقرآن على الناس، وفهما معينا للعقيدة الإسلامية. وكانت ثورة الإمام أحمد ان رفض تسلط الدولة على الدين، فاضطهد وعذب، ولكنه في النهاية استطاع ان يؤلب الرأي العام على الدولة حتى تراجع المأمون عن فكرته، وظل العالم الإسلامي اليوم عالما لا تسيطر عليه أي كنيسة، وظلت اقطار تتبع هذا المذهب، وأخرى ذاك، من دون ان يسلم للدولة بأن لها سلطانا على الدين.
لذلك في حين تمحور الاشكال الغربي حول كيفية تحرير الدولة من الدين، مما أدى الى ثورات كبيرة لنيل هذه الغاية، فإن وجها من وجوه الإشكالية عندنا هو كيف نحرر الدين من الدولة، ونمنعها من التسلط على الدين، وأن يظل هذا الأخير شأنا مجتمعيا متاحا لكل المسلمين بأن يقرأوا القرآن ويفهموا ما شاؤوا. ولا بأس في التعدد الذي يفرض قدرا كبيرا من التسامح. أما إذا احتاج المسلمون إلى قانون، فالآلية الديمقراطية المعاصرة هي خير تجسيد لقيمة الشورى في الإسلام بحيث لا يكون الاجتهاد حينئذ فرديا بل جماعيا من قبل ممثلي الشعب.
غياب الكنيسة مهم جدا في تراثنا ربما إخواننا الشيعة فقط هم الذين عندهم فكرة المؤسسة الدينية، بينما لا توجد في العالم السني مؤسسة دينية، بل توجد فقط مؤسسة علماء، وهؤلاء بطبيعتهم مختلفون وآراؤهم مختلفة. ولهذا نظل نحتاج الى آلية لسن القوانين، ولا نحتاج الى عالم واحد، وإنما الى جملة العلماء والمثقفين يتداولون في مناخ من الحرية، وفي النهاية مؤسسة التشريع هي الوحيدة المخولة لسن القانون لأنها منتخبة.
إذا احتجنا إلى سن قانون في ظل التعدد لا بد لنا من آلية،و لعل أفضل آلية توصل إليها البشر اليوم هي الآلية الديمقراطية و الآلية الإنتخابية. تشهد الساحة السياسية التونسية، اليوم، تجاذبا بين تيارات علمانية قد ننعتها بالمتشددة، وتيارات إسلامية أيضا قد تنعت بنفس الاسم والصفة، أحدهما يريد فرض اجتهاد في الإسلام من فوق وبأدوات الدولة، اما التيار الاخر فيريد تجريد الدولة من كل تأثر بالإسلام، ويريد تجريد القانون وبرامج التربية والثقافة من كل تأثير ديني في المجتمع. أغرب ما في الأمر ان مجتمعنا لا يتجه الدين فيه الى انحسار الديني، بل يعرف صحوة واسعة، كما هو الحال في مواطن شتى من العالم كله. وليس ببعيد عنا ما قامت به الكنيسة الكاثوليكية من دور في تطوير أوروبا الشرقية، انطلاقا من القس البولوني البابا جون بول الثاني، ودور الدين في إيصال بوتين الى منصب الرئاسة حيث احتاج الى دعم القس الأكبر للارثوذكس. ففي زمن يشهد فيه العالم صحوة دينية – لا سيما العالم الإسلامي- هناك من يعترض على أي تأثير للدين في سياسات الدولة التعليمية والثقافية. ولكننا، في الحقيقة، لسنا بحاجة الى ان يفرض الإسلام بأدوات الدولة، فالنفوس تجافي كل ما يفرض عليها. ان الإسلام دين شعب وليس دين نخبة، وإنما العامل الأساسي في استمراره ليس هو نفوذ الدولة، ولكن ما يتمتع به من قبول عام لدى معتنقيه، والدولة في كثير من الأحيان كانت كلا على الإسلام. ومع هذا يخشى الكثير ممن ينتمون الى التيار الإسلامي وغيرهم من تحرر الدين من الدولة، وأن يترك الدين شأنا شعبيا. انهم لفي خشية وتوجس شديدين من الحرية على الإسلام، وهو أمر يبعث على الأسى.
ان موضوع حياد الدولة فيه قدر غير قليل من المغامرة، إذا كان المقصود هو فصل الدين عن السياسة، باعتبار الدولة منتوجا بشريا والدين تنزلا الهيا. لقد كان التمييز واضحا عند المسلمين الأوائل بين ماهو وحي وماهو سياسي، لكن اذا اردنا الفصل، بالمعنى الفرنسي او تبعا للتجربة المراكسية، فقد نقدم على مغامرة تضر بالاثنين. ان تحرر السياسة من الدين هو تحويل الدولة الى مافيا والاقتصاد في العالم الى نهب، والسياسة الى نوع من الخداع والدجل، وهذا ما انتهى اليه الامر في التجربة الغربية، رغم بعض ايجابياتها. فالسياسة العالمية أصبح يتحكم فيها مجموعة من السماسرة الماليين المالكين للمال، وبالتالي للإعلام، ويسيطرون في النهاية على السياسيين.
كذلك حاجة الناس الى الدين حاجة عميقة، لأن الإنسان في حاجة الى موجهات روحية وموجهات قيمية، فعندما تختلط عليه الأمور يحتاج الى مفهوم الحلال والحرام وأن يميز بينهما. وفي غياب كنيسة تحتكر النطق باسم الحلال والحرام يبقى المجال للتداول بين الشعب والنخب، عبر المفكرين ووسائل الإعلام.
عندما يتحرر الدين من السياسة والدولة، هذا التحرر أيضا قد يكتسي خطورة، لأنه قد تقع انفلاتات ويخرج الأمر عن مجاله. فالسبيل، إذا، الى معادلة تضمن فيها حريات الناس وحقوقهم، لأن الدين جاء من أجل ضمان حقوق الناس وحرياتهم، هو الرجوع الى موضوع التمييز بين الدين والسياسة، ونحتاج الى ضبط ثوابت الدين ومتغيراته.
نحتاج الى ان يكون المشرعون متشبعين بقيم الدين حتى اذا أرادوا ان يشرعوا، فلا يحتاجون الى وصاية من وزارة الأوقاف، ولا وصاية من وزارة الأوقاف، ولا وصاية من علماء الشريعة لأنهم متشبعون بهذه القيم. وكذلك سائر السياسيين، فهم كلهم يصدرون لا عن الاكراه الخارجي وإنما عن قناعتهم، لأنه لا قيمة لأي ممارسة دينية تصدر عن الإكراه. لا فائدة من تحويل الناس عبر أدوات الدولة القهرية من عصاة الى منافقين، فالله سبحانه وتعالى خلق الناس أحرارا، اذا يمكن السيطرة على ظواهر الناس، لكن لا يمكن فعل ذلك على بواطنهم.
الدين مداره الأساسي ليس أدوات الدولة وإنما القناعات الشخصية، اما الدولة فمهمتها تقديم الخدمة للناس قبل كل شيء كمواطن الشغل والصحة الجيدة والمدرسة الجيدة، اما قلوبهم وتدينهم فأمرها الى الله، اذ ان اعظم قيمة في الإسلام هي قيمة الحرية. ولذلك فالدولة منتسبة الى الإسلام بقدر ما تحرص على أن تتماثل بقيمه بدون وصاية من مؤسسة دينية، لأنه ليس هناك مثل هذه المؤسسة في الإسلام، بل هناك شعب وأمة يقرران لنفسهما عبر مؤسساتهما ماهو الدين.
لذلك عندما أعرض اهل مكة عن الدين، اقترح عليهم النبي خيارا اخر ان "اخلوا بيني وبين الناس"، ولو فعلوا ذلك لما احتاج ان يهاجر ويغادر وطنه. الا ان بسبب ما كان لدعوته من قوة الحجة ومن جاذبية ما استطاعوا ان يواجهوها بأطروحة أخرى، ولذلك يعتبر المسلمون حجة الإسلام قوية، ولا يحتاجون الى ان يمارسوا معها الإكراه على الناس، فعندما يقول صوت الإسلام "هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين"، هذا التحدي لا يقال في واد لا أنيس له، وإنما يطرح هذا المسلم تحديه في قلب الصراع الفكري والسياسي.
العلمانية ليست بالفلسفة الالحادية، وإنما هي إجراءات وترتيبات لضمان حرية المعتقد والفكر فجانب كبير من المناقشات والجدل الذي يدور في خضم هذا الصراع، ببلادنا اليوم، هو التباس في المفاهيم حول العلمانية وحول الإسلام في نفس الوقت. يرفع جزء مهم من هذا الالتباس لو استبنا ان العلمانية ليست بالفلسفة الالحادية، وإنما هي إجراءات وترتيبات لضمان حرية المعتقد والفكر. ولذلك ميز عبد الوهاب المسيري في كتاباته بين علمانية جزئية وعلمانية شاملة مثل تلك التي يمثلها النموذج اليعقوبي في تاريخ فرنسا الذي شن حربا على القساوسة ورفع شعار "اشنقوا اخر ملك بأمعاء اخر قسيس". وهذا المفهوم للعلمانية يعبر عن خصوصية فرنسية، وليس معبرا عن العلمانية باعتبارها ترتيبات إجرائية لضمان الحرية في المجتمع.
وهناك بنفس القدر أيضا، غموض حول الإسلام لدى من يعتقد ان الإسلام سينتصر اذا صادر حريات الناس وفرض الصلاة والصيام والحجاب بالقوة، في حين يعتبر هذا لو حدث فشلا وليس نجاحا، إذ لا ينتج اكراه الناس على الدين الا منافقين، وقد اعتبر الله سبحانه وتعالى النفاق اكبر جريمة، إذ المنافقون في الدرك الأسفل من النار، وهم أسوأ فئة من الناس.
ينبغي علينا اذن ان نقبل مبدأ المواطنة، وأن البلاد ليست ملكا لزيد أو لعمر أو لهذا الحزب أو ذاك، ولكنها ملك لكل مواطنيها، وهم جميعا، بغض النظر عن معتقداتهم او اجناسهم ان كانوا ذكورا أو اناثا، اعطاهم الإسلام الحق ان يكونوا مواطنين يتمتعون بنفس الحقوق: بأن يعتقدوا بما شاءوا ضمن اطار احترامهم لبعضهم البعض، وأن يتصرفوا رفق القانون الذي هم يسنونه عبر ممثليهم في البرلمان.

تقديم ترجمة إنقليزية لكتاب الأستاذ راشد الغنوشي الحريات العامة في الدولة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية
03:10:46 2022/10/28تقديم ترجمة إنقليزية لكتاب الأستاذ راشد الغنوشي الحريات العامة في الدولة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية ...

محاضرة الشيخ راشد الغنوشي: التوافق و صناعة الاستثناء التونسي أفق و مسارات
11:05:41 2015/05/12...


.jpg)

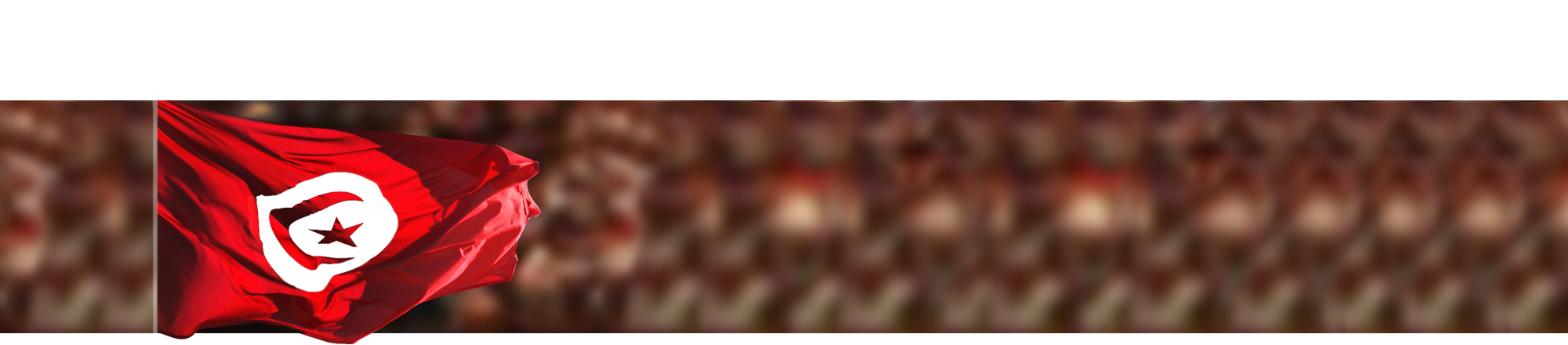




.png)
